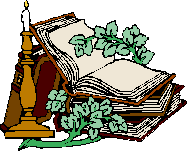|
||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
فلسفة
اللاعنف
(1
من 2)
ديفيد
مكرينولدز
هذه
الملحوظات محاولة لإيجاز الأساسيات في فلسفة
اللاعنف. إننا نكتب عن اللاعنف ونتكلَّم عليه
كما لو كان مجرَّد تقنية. أعتقد، من جانبي،
أنه أكثر من ذلك بكثير، أنه "فلسفة ذات حدٍّ
واحد" لا تنقاد بسهولة لاستعمالها ذوْداً
عن الظلم أو تشجيعاً عليه وهي غير ذات قيمة ما
لم توضَع على محكِّ العالم الواقعي. عندما
انضممت إلى الحركة السِّلمية عام 1948 كان
مفهوم اللاعنف كطريقة في التغيير منهجاً
جديداً على الولايات المتحدة، وكان النتاج
المباشر لتعاليم غاندي وأعماله في الهند.
وكان يُنظَر إلى اللاعنف تاريخياً إما كتعبير
عن الأناجيل، وإما كتنويع على فلسفة ماركوس
أوريليوس الرواقية. لكنْ لا التعاليم
المسيحية ولا التعاليم الرواقية زوَّدتنا
بمنهج للتعامل مع الظلم، باستثناء التحمُّل.
كان هذا حسناً لو أنني كنتُ الشخص المُعاني،
لكنه لم يكن ليزوِّد بطريقة لمنعك من إنزال
الظلم بفريق ثالث. لقد كان بوسع المسيحي أن
يختار معاناة ظلم شديد – ولكن ماذا عن غير
المسيحي الذي لم يفعل شيئاً يستحق عليه
العذاب، وكان يسعى إلى الخلاص منه؟ مشكلة
التعامل مع الشر
بعد
الحرب العالمية الثانية بخاصة، مع فظاعات
الإبادة الجماعية، كان ثمة إحساس بأن
السِّلمية وحدها – رفض القتل – لم تكن جيدة
بما يكفي. قدَّمت الشيوعية جواباً لكنه كان،
كما عبَّر عنه لينين وتروتسكي، جواباً تبرِّر
فيه الغايةُ الوسيلةَ، ومع حلول عام 1945 بدا من
الواضح أن الشيوعية، في أحسن الأحوال، كانت
"شراً أقل" من الفاشية. في هذا الخواء،
هذا "المكان التاريخي" الذي وجدنا
أنفسنا فيه يجابهُنا واقع أن أناساً من نحو
هتلر وستالين موجودون، أن القنبلة الذرية
كانت بالإمكان خطوة أخيرة في التاريخ البشري،
اعتنقتْ الحركة السِّلمية ما ندعوه اليوم بـ"اللاعنف"
في مقابل كلمة "السِّلمية" السابقة. عندئذٍ
انتسبتُ إلى الحركة السِّلمية، بما أن
الأفكار القديمة والأفكار الجديدة كانت
تُستكشَف وتوضع على محك الاختبار. ولقد كان من
عجائب التاريخ أن اللاعنف، حين عاد إلى
الدخول إلى الحياة الأمريكية، كان عبارة عن
بضاعة رُدَّت إلى أصحابها. كان تولستوي قد قرأ
مقالة هنري ديفيد ثورو في العصيان المدني،
وكان غاندي قد قرأ تولستوي، وكان مارتن لوثر
كنغ الابن قد قرأ غاندي. كان إيديولوجية طافت
حول العالم، مؤثِّرة بكل ما يصادفها ومتأثرة
به. ما
من إيديولوجيا بدون ثغرات
من المهم، لدى محاولة فهم
فلسفة اللاعنف، ألا يغيب عن البال بأنه ما
من فلسفة حية، حيوية، خالية من "الثغرات".
دعوني أعطي مثالين على ذلك. تنطوي الماركسية (وأنا
مدين لماركس بدَيْن باهظ) على تناقض ملازم لها
في كونها حاججتْ بأن "التاريخ إلى جانبنا،
الاشتراكية لا محيد عنها من جراء التناقضات
التي سوف تقود إلى انهيار الرأسمالية". حسن، إذا كانت الاشتراكية لا محيد
عنها، لِمَ، إذن، لا يستريح المرء ويلبث
منتظراً إياها؟ لِمَ يخاطر بحياته – كما فعل كل هؤلاء
الاشتراكيين والشيوعيين الشجعان – في صراع
كانت نهايته مؤكدة مسبقاً؟ تقصُّ علينا البوذية، التي
أنا مدين لها شخصياً هي الأخرى، بأن بوذا جلس
تحت شجرة، تأمل، واكتشف الحقيقة، التي كان
اللاتعلُّق جزءاً كبيراً منها. لم، إذن،
تكبَّد مشقة تعليمها؟ لو أن بوذا كان فاز
بالجواب، لِمَ كان لا يزال من "التعلُّق
بالعالم" بحيث علَّم أصلاً؟ في كلتا
الحالتين سمعت الجواب – وهو لا يقنعني.
فالفلسفات، تلك التي من شأنها تغيير مسار
الحياة، وتغيير التاريخ، موسومة بالتناقضات.
وحدها الإيديولوجيات الصغرى تملك كل
الإجابات. ليس في اللاعنف جواب على كل
الأسئلة. إنه مليء بالتناقضات. وفهمي الشخصي
للاعنف مزيج من أشياء قرأتها في غاندي،
سمعتها من بايارد رَستِن وأ. ج. موسته، من
قراءة الفلسفة الشرقية والأناجيل وكارل
ماركس إلخ. وفيما يلي محاولة لإيجاز ما
تعلَّمت، عالماً بأنه لا توجد لدي فكرة واحدة
أصيلة. الافتراض
الأساسي للاعنف
فلنبدأ بافتراض أساسي
للاعنف. هناك حقٌّ مطلق، لكنْ ما من أحد منَّا
واثق مطلق الثقة من ماهيَّته. كل منَّا يرى
جزءاً منه، وما من أحد منَّا يستطيع الإحاطة
به قاطبة. فلنفكر بالحق – "العالم الحق"
– بوصفه الأرض نفسها. إذا سألنا ثلة من الناس
المنتشرين عن "ماهية حقيَّة الأرض"
سيجيب الرجل القاطن في جزيرة صغيرة في المحيط
الهادي بأنها تكاد تكون بمجملها الماء،
باستثناء بقعة اليابسة التي يحيا وأسرته
عليها. وستجيب امرأة من كنساس بأنها مفلطحة،
جافة، إلا عندما تمطر السماء، وبأنها مغطاة
بالقمح. والبدوي الراحل في الصحراء سوف يقول
إن الأرض جافة، رملية، لا تني تتحرك مع الريح،
وليس فيها إلا نبات قليل. والصياد في الغابة
المطرية البرازيلية سيصرَّ أن الأرض مبللة
بالماء، أن الهواء مشبع بالرطوبة، والنهار
مليء بأصوات الطيور والحشرات، والنبات من
الكثافة بحيث تصعب الحركة. كل تصريح من التصريحات
السابقة صحيح – كجزء من الحقيقة. وما من
واحد من التصريحات يصح على الكل. ومع ذلك
كثيراً ما نعتقد أن الحقيقة الجزئية التي
ندركها هي الحقيقة الكاملة. بعبارة أخرى –
يدرك كل كائن إنساني "الحق" بطرق مختلفة.
وذلك الفارق عند غالبيتنا هو من الدقة بحيث
إننا لا نلحظه. لكن الأمر يصير مهماً عندما
يكون الشخص مصاباً بعمى الألوان ولا يستطيع
أن يميز بين الأحمر والأخضر – وذلك سبب كتابة
كلمة قف على إشارات الوقوف وعدم الاكتفاء
بالإضاءة الحمراء (وهو أيضاً سبب كون الأحمر
هو اللون العلوي في إشارة المرور الضوئية،
والأخضر هو السفلي – إذ يستطيع أعمى الألوان
أن يميز الفارق بين موقعيهما). أما الأطرش أو
الأعمى منذ مولده فهو يحيا في عالم لا يقل "حقيَّة"
عن العالم الذي تحيا فيه أنت، لكن "حقَّهما"
عميق الاختلاف. نحن، فرادى، كائنات منتهية
في كون، بمقدار ما نستطيع أن نعلم، لانهائي.
ولسنا على يقين من أن للكون بداية ونهاية –
لكننا متأكدون من وجود بداية لنا وأنه ستكون
لنا نهاية. وهناك حدٌّ للزمن الذي نستطيع
إبَّانه تعلم بعض الأمور – والأمور التي يجب
أن نتعلمها أكثر بكثير من أن يحق لأي منَّا أن
ينصِّب نفسه مرجعاً، اللهم – في أحسن الأحوال
– إلا بطرق صغيرة ومحدودة. قد نكون على يقين مطلق –
مثلي – أنه وراء أوهام عالم صلب (وهم، لأن
العالم الصلب مصنوع من دقائق غير معقولة
الضآلة من الطاقة مشدود بعضها إلى بعض على نحو
يوهم بأنها مقاعد، طاولات، بشر، إلخ) هناك "حق"
ما. لكني على يقين مطلق، لأني منتهٍ والحق
لانهائي، أني لن أستطيع أن أكون على يقين مطلق
من حقيقة أي شيء حقيقة مطلقة. أعتقد بوجود
حقيقة، لكني لا أعتقد بأني سأكون على يقين
منها أبداً. إلى
أين يقودنا هذا العبث؟
يبدو لنا هذا كله شديد
التلوِّي ولكن دعونا ننظر إلى غاندي الذي قال:
"الحقيقة هي الله، الله هو الحقيقة." لقد
عَنْوَنَ سيرته الذاتية بـ"تجاربي مع
الحقيقة". من السهل أن يفوتنا جوهر ما كان
غاندي يقوله لأنه كان من الوضوح بمكان. عندما
سأله رجل غربي عما إذا كان يؤمن بالله أجاب
غاندي وهو يربت على حجر: "الله حتى في هذه
الحجارة." وهذا جزء من معتقد هندوسي بأن
الله ليس، كما هي عليه الحال في الغرب، منفصلاً
عنَّا، شخصياً ومع ذلك قصياً – الله، بالحري، لاشخصي ويتخلل كل شيء. من الصعب رسم
خط فاصل بين هذا المعتقد وبين نوع من الإلحاد
الديني. بالمعنى الهندوسي "الله هو كل
الأشياء"، بحيث إن قول غاندي بأن "الله
هو الحقيقة" كان تصريحاً من شأن العالِم أن
يفهمه فهماً أكثر فورية من بقيَّتنا. لقد كانت هناك دوماً بنظري
صلة بين هذه الرؤية وفكر ماركس، حيث إن صرح
الماركسية برمَّته بُنِيَ برصد العالم
المادي، ببحث عن الحقائق، بإصرار على ضرورة
أن تعكس النظريات "الواقع المادي". لقد
صرف كارل ماركس وموهنداس غاندي كلاهما وقتاً
طويلاً يحاولان إيجاد الوقائع العينية عن
الأوضاع. قام ماركس بعمله بين أكوام
الكتب في المتحف البريطاني، بينما اطَّلع
غاندي على التقارير، وقرأ الإحصاءات، واستمع
إلى الفلاحين، وفتَّش عن الحقيقة قبل أن
يتوصل إلى نتيجة. ما من واحد من الرجلين جلس
وحده، تأمل، وانتظر وصول الحقيقة إليه على
أجنحة المنطق الصرف. لا – وحده الرصد كان
يعيِّن الحقيقة. هناك في غاندي شيء من العالِم
الصرف، الفيزيائي، المستعد لاختبار صحة
أرصاده. البحث
عن الحقيقة كأرضية مشتركة
لئن كان بحث غاندي عن
الحقيقة يرى "الله بوصفه الحقيقة" فمن
الممكن حينئذٍ لـ"غير المؤمن" أن يقارب
غاندي بالبحث عن الحقيقة كأرضية مشتركة. ولكن
– ولسوف نعود إلى هذا مراراً وتكراراً – بما
أن غاندي كان على وعي أنه لم يكن بوسعه أن يستيقن
من كونه على صواب فإنه لم يكن مستعداً
لتدمير الآخرين في اختباره للحقيقة. هو، نعم،
ولكن ليس الآخرين. لقد كان على وعي (والماركسيون
ينزعون إلى عدم وعي) أن إدراكه للحق كان
دوماً، بطبيعة الأشياء، "جزئياً وغير تام".
ولقد كان يعلم أن خصمه أيضاً يرى جزءاً من
الواقع الحقيقي. وقبول هذا والاعتراف به أمر
شديد الصعوبة علينا. الجنرال يرى جزءاً من
الواقع؟ نيكسون كان يرى جزءاً من الواقع؟ أجل. دعوني أنهي هذا "الفصل"
الأول بذكر أن واحداً من الأشياء التي تركت
فيَّ عميق الأثر عن المرحوم أ. ج. موسته كان
قدرته على الإصغاء باحترام إلى أولئك
الذين كان على خلاف عميق معهم، ليس كتكتيك
بل لأنه كان يأمل أن يقبض في ملاحظاتهم حقيقة
ما ربما فاتته. إن معظمنا، في المحاججة،
يكاد لا يستطيع أن ينتظر حتى يفرغ "الخصم"
من كلامه لكي "يصحِّحه" (أو "يصحِّحها").
لم يكن أ. ج. مستعجلاً "تصحيح" خصمه، ولا
غاندي كان كذلك. اللاعنف يتضمن أشياء كثيرة،
لكنه إذا لم يكن بحثاً عن الحقيقة – بحثاً لا
ينتهي أبداً – فسوف يخفق. حتمية
النزاع
يفترض اللاعنف أن النزاع
حتمي لأن التغير حتمي، ومع التغير يأتي
النزاع. فإن وُجِدت نظرة تقليدية ترى
السِّلميين كـ"مسالمين" (بغض النظر عن
كوننا نتسبب عادة في مشاكل كثيرة، كوننا غير
موالين بطبيعتنا) فإن فلسفة غاندي تفترض أن
"الواقع" الذي نراه زائل، وأن التغير
والنزاع هو القاعدة، وليس الاستثناء. هذا النظرة إلى العالم
قديمة جداً – لقد علَّم هيراقليطس (الفيلسوف
الإغريقي الذي عاش حوالى 535-475 ق. م.) بأنه لا
يوجد واقع دائم سوى واقع التغير – كما تمثِّل
له عبارته "لا يمكنك أن تخطو مرتين في النهر
عينه". وهذا أيضاً، من أكثر من وجه، هو جوهر
الماركسية – كل ما نرصد هو في حالة تغير. وقد
يسعفنا أن نفكر بعالم "الواقع" وكأنه ماء
في صيرورته إما بخاراً وإما جليداً – إذ يبدو
أنه لا يحدث تغير حتى يقع فجأة تغير عظيم. (تذكروا
كيف انشرخت مؤسسة جيم كراو فجأة بدءاً من
كانون الأول 1955 في مونتغومري، ألاباما.) كان هذا بنظر غاندي،
الهندوسي، افتراضاً سهلاً، باعتبار أن
الهندوسية تعتقد أن الواقع الذي نراه برمَّته
وهم، يغطي واقعاً أعمق، سرمدياً، غير قابل
للعلم. ونحن، إذ نفكر في غاندي، لابدَّ لنا من
فهم دور البْـهَـغَـفَـدغيتا (وتعني "أنشودة
الرب") في حياته وتفكيره. الغيتا قديمة جداً
– تعود ربما إلى ما بين القرنين الخامس
والثاني ق. م. وهي قصيرة نسبياً – النسخة
الورقية الغلاف التي أملكها لا تتعدى 140 صفحة.
(مطبوعة عام 1954 عن "المكتبة الأمريكية
الجديدة"، وفي لون صفحاتها البني وهشاشتها
برهان على عدم استقرار المادة!) وباعتبارها
أكثر الأعمال في الكتب المقدسة الهندوسية
تمتعاً بالشعبية، كان غاندي ضليعاً بها شأن
ضلوع المسيحي التقي بالأناجيل. أود هنا أن أقتطف مقطعاً
يتعلق بمعركة كبرى كان أرجونا، المقاتل، على
وشك الاشتراك فيها. إنه، وهو ينظر إلى المشهد
الذي سيصير ساحة الوغى الدامية، يلجأ إلى
الرب كرشنا، التجسُّد الإلهي، ويقول: "كيف
لي أن أؤذيهم؟"
كرشنا، كرشنا، / وأنا أنظر /
إلى أقاربي هؤلاء / مصطفِّين للمعركة، / ترتخي
ساقاي، / يجف فمي، / يرتجف جسمي، / ينتصب شعري، /
يحرقني جلدي، / قوس غانديفا / يسقط من يدي، /
دماغي كالدوامة / يدور ويدور، / لا أطيق
احتمالاً أكثر: / كرشنا، أرى / ما ينذر بالشر! /
ماذا يمكننا أن نأمل من / مقتل الأقارب؟ / ما
شأني و / النصر، المُلك، / أو التمتع بهما؟ /
أيا [كرشنا]، / كيف لي أن أهتم / بالسلطان أو
بالملذات، / وحتى بحياتي نفسها، / وهؤلاء
الآخرون جميعاً، / معلمين، آباء، / جدوداً،
أعمام، / أبناء وإخوة، / أصهاراً، / أحفاداً
وأبناء عمومة، / الذين من أجلهم فقط / يمكنني
أن أتمتع بها / يقفون هنا مستعدين / للذود
بالدم والمال / في الحرب ضدنا؟ يا عالماً بكل شيء، / حتى إذا
اتفق لهم أن يذبحوني / كيف لي أن أؤذيهم؟ / ليس
بمقدوري أن أتمنى ذلك: / أبداً، أبداً، / ولو
أكسبني ذلك / عرش العوالم الثلاثة / فكم بالحري
أقل / سيادةَ الأرض! / كرشنا، أيها السامع /
صلوات البشر قاطبة، / قل لي كيف يمكن / أن نأمل
بالسعادة / ونحن نهمُّ بذبح أبناء /
دهريتاراشترا؟ / لعلهم أشرار، / وأسوأ
الأشقياء، / ومع ذلك، إذا قتلناهم / ستكون
خطيئتنا أعظم، / كيف نجرؤ على إهراق / الدم
الذي يربطنا؟ / أين الفرح في / قتل الأقارب؟ /
أية جريمة هذه / أخطط لها، أيا كرشنا؟ / قتل
مكروه للغاية، / قتل الإخوة! / أأنا فعلاً /
بهذا الجشع إلى العظمة؟ / بدلاً من هذا / دعِ
الأشرار من أبناء / دهريتاراشترا / يأتون
مدجَّجين بسلاحهم / ضدي في المعركة: / لن
أقاتل، / لن أضربهم. / ليقتلوني، / فهذا أفضل. ويستجيب كرشنا، مبيِّناً أن
كون أرجونا مقاتلاً يوجِب عليه خوض المعركة –
"إذا أحجمت عن خوض هذه الحرب الشريفة، فسوف
تتخلَّى عن واجبك. سوف تكون خاطئاً وتسقط من
منزلتك... ولسوف يظن الزعماء المقاتلون أن
الخوف هو الذي جعلك تحجم عن المعركة." غاندي
وكرما يوغا
ويتابع كرشنا شارحاً لكرشنا
درب "كرما يوغا" الذي هو "يوغا العمل".
(نحن نألف اليوغا بوصفه ضرباً من الرياضة –
بينما في الهندوسية توجد ضروب متنوعة من
مناهج اليوغا – أحدها "كرما يوغا" الذي
هو السعي إلى الوحدة مع الإله عبر الأعمال
الطيبة، بدلاً من التأمل. من هنا يجب أن نرى في
غاندي، فيما إذا قُيِّض لنا أن نفهمه،
هندوسياً اتَّخذ درب كرما يوغا.) إن نص الغيتا، بنظر أهل
السُنَّة من الهندوس، يكاد يعدم أي ذكر
للاعنف. بل يبدو، على العكس، دفاعاً عن قيام
المرء بواجبه العسكري. بيد أن غاندي، غير
المتسنِّن من وجوه كثيرة، كان غير متسنِّن
هنا أيضاً، وقد رأى في اللاعنف – درب
المقاومة المُحِبة، درب "قوة الحق" أو ساتياغراها
– طريقاً للخروج من مشقة الانخراط في ذبح
إخوانه. أجل، لقد قبل القيام بواجبه وكأنه
ينتمي إلى طائفة المحاربين، لكنه حوَّل طبيعة
المعركة نفسها. لقد غلوت في تكثيف ما ينبغي
أن يُقرأ برمَّته – إذا كان النص بترجمة
سوامي بربْهَـفَـنندا وكريستوفر أيشروود ما
يزال متوفراً، فهو يستحق القراءة بحق. [ملاحظة
المحرر: النص متوفر وبالوسع قراءته. يتعذر على
المرء الإحاطة بفلسفة اللاعنف كما بسطها
غاندي بدون العودة إلى هذا المصدر.] كان الأمل، بنظر غاندي، أنه
إذا أمكن لكل نزاع أن يُحَلَّ عبر اللاعنف فإن
النزاع التالي يحصل على "مستوى أعلى" –
وهو صدى، توصَّل إليه هندوسي، لفكرة ماركس
بأن الديالكتيك لابدَّ أن يقود إلى تغيير
إيجابي. وبعبارات عملية ليس ثمة فارق كبير بين
"الديالكتيك المادي" لماركس وفكر غاندي،
رغم أن الأول كان متجذِّراً في نبذ الدين
بينما كان الثاني متجذِّراً فيه. التاريخ
كله، بنظر ماركس، كان سيرورة "ديالكتيك
مادي" بين الجنس البشري في صراعه مع
البيئة، فيما الثقافات المنبثقة من ذلك
الصراع تعكسه – بذلك كانت "آلهة"
القبائل الرحَّل مختلفة عن "آلهة" حياة
المدن الأولى. مفهوم الله يتطور من مفهومه في
التوراة، حيث كان إله اليهود واحداً من آلهة
عديدة – لكنه وحده الذي يجب على اليهود أن
يعبدوه – إلى الله الذي تكلم عليه يسوع، الذي
كان واحداً وكلياً. وبالطبع، من أساسيات فكر
ماركس أن البنى الاجتماعية تعكس سلطة مالكي
وسائل الإنتاج. فرادة
الكيان
هناك سطر واحد ملفت من
الغيتا يقع من اللاعنف في القلب: "من كل
عجائب العالم، أيُّها الأعجب؟... أنه ما من
إنسان، مع أنه يرى الآخرين يموتون من حوله،
يعتقد أنه سوف يموت." الموت معطى أصلي. حياتنا
فائقة الأهمية بنظرنا – هي اختبارنا الوحيد
للوعي – ومع ذلك يجب أن نتوصل إلى وفاق مع
نهايتها المحتومة. فعلى الأقل فيما يخص
الملحدين منا ليس هناك آخرة. إن ما يجعل
اللاعنف بهذه القوة هو جزئياً احترامه
للطبيعة الفريدة لكل شخص. لم يوجد أي واحد
منَّا من قبل، ولن يتكرر من جديد. ينطوي كل منا
على نوع من "الكون الخاص" للخبرة. من
الخير أن نحيا، من الخير أن نختبر الحياة، من
الخير أن نستمتع بهذه الخبرة، من الخير أن
نبتهج بعجائب الحياة. فمن باب أعجل، إذا لم
نكن هنا إلا لمرة واحدة، سريعة، أن نشعر
بأحقِّيتنا في اختبار المسرَّات. فرادة الكيان الخارقة هذه
هي التي تجعل السِّلمي بهذا الإحجام المطلق
عن تدمير شخص آخر؛ إذ إن كوناً بأسره ينتهي مع
كل ميتة، ولا يمكن تعويضه. أية عجيبة خارقة هي
صنعتنا، وأي اختلاف هو الاختلاف فيما بيننا.
إن احترام فرادة كل شخص وفهمها قد يجعل
بالإمكان أيضاً استشعار ما نحن مشترِكون فيه،
حتى إذا لم يكن ما نشترك فيه غير اليقين من
نهايتنا. ومع ذلك يجب أن نتصالح مع واقع أننا
سوف نموت. ما ينبغي أن نحجم عنه هو القتل –
وحده ذاك هو خيارنا. نحن نجيء في قياس وهيئة
وجنس ولون مختلف، يحمل كل منَّا ذاكرات
ثقافية وعائلية مختلفة. اللاعنف يتناول
مجتمعاً يتمكن فيه كل شخص، بدلاً من جعل الناس
ينصاعون لمعيار معين، أن يحقق، في أثناء
حياته أو حياتها، أعظم كمون له أو لها. الموت
بوصفه بُعْداً
ومع ذلك... من المؤكد أن
حياتنا سوف تنتهي عند نقطة ما. إن الاستمتاع
بالحياة يقتضي – يا للغرابة! – إدراك البُعد
الذي يضفيه عليها الموت. فلو كان مقيَّضاً لنا
أن نحيا إلى الأبد لكان كلُّ يوم أقل قيمة –
إذ تكون أيامنا غير منتهية. (تماماً كما أن
شخصاً لا يملك إلا ورقة بعشرة دولارات
يثمِّنها أغلى بكثير من شخص لديه غرفة مكتظة
بهذه الورقات.) إن ما يجعل حياتنا بهذه الروعة
هو بالدقة "الطبيعة المنتهية" لحظِّنا
في اختبارها. وإن استعدادنا لئلا "نتعلق"
بالعالم المادي، ولإدراك أن الموت سوف يسترجع
منَّا كل ما نملك، هو الذي يضفي على الحياة
اليومية نكهتها. إن القول الشعبي "من يمُتْ
وفي حوزته ألعاب أكثر يَفُزْ" يوجز الموقف
المغلوط – إذ ماذا يفعل رجل ميت بألعابه؟ لكم
كان أبهج أن نقول: "من ينزل عن ألعابه قبل
حدِّ الأمد يَفُزْ." وإني لأذكر بايارد
رَسْتِن معلقاً ذات مرة أن الثياب المعلقة في
خزانتك التي لم تلبسها في العام المنصرم لا
تعود ملكاً لك – فجليٌّ أنك لم تكن بحاجة
إليها وينبغي أن تعطيها لمن يحتاج إليها. يرد
في الأناجيل المسيحية [متى 12: 16-21] مثلٌ عن رجل
غني جمع أرزاقاً عظيمة تكفيه مؤونة سنين
عديدة، فقال له الله: "يا غبي! الليلة
تُسترَدُّ نفسُك منك – فلمن يكون ما أعددته؟" كذا فإن اللاعنف فلسفة
تتأسس على افتراض التغير، وعلى إدراك أن ذلك
التغير سوف يتسبب في الألم والظلم. (فكِّر في
جمبلز، وولوورث والاتحاد السوفييتي!) وتوخياً
لجدية أكثر فكِّر في الثورة الصناعية، وفي
شقائها الوحشي. (إذا قارنتَ بين فظاعة مدة
ستالين القصيرة في السلطة والملايين الذين
ماتوا إبان مدَّته فيما كانت روسيا تتصنَّع
بحشرجة القرن، وأكثر بالثورة الصناعية، فإن
الشقاء ليس بهذا الاختلاف – فقط في الإطار
الزمني.) النضال ضد العنصرية الذي يجد الناس
الطيبون أنفسهم فيه واقعين في شرك مفاهيم
قديمة. فكِّر في نضالات العمل، حيث تنظيم
النقابات مراراً ما شَرَخَ عائلات برمَّتها
– الأغنية النقابية القديمة "أي طرف
تُناصِر؟" اللاعنف يعني مجهوداً "للجهاد
ضد الظلم" بدون المجازفة بتدمير خصومنا،
لأننا لا يمكن أن نكون على يقين مطلق من كوننا
على حق (سبق أن تناولنا هذه الفكرة)، وكذلك لأن
الذين نعارضهم لا يقلون عنا فرادة. على جزء من فلسفة اللاعنف أن
تجابه مشكلة "اللاتعلق" بالمادية وكذلك
بالحياة حتى – وهذا لمن قبيل المفارقة لأننا
نضفي على الحياة ثمناً غالياً جداً. أريد الآن
أن أتناول مفارقة مفادها أننا، لكي نحقق
العدل، علينا أن نقبل وجود الظلم. ظلم
النضال من أجل العدل
الخبر السيئ أولاً.
شعار "لا سلام بدون عدل" شعار شعبي، لكنه
شعار مجازف. فمن شأنه أن يُقلَب فيُقرأ "لا
عدل بدون سلام". إن الكثير جداً من مناقشة
التغير الاجتماعي يديره أناس ليسوا أنفسهم
مقموعين، وهم، بالتالي، يظنون أن الحياة
ينبغي أن تكون عادلة. الحياة ليست عادلة.
فسيرورة التغير الاجتماعي سيرورة مصدوعة
وعميقة الظلم. أما الخبر الجيد فهو أن ذلك
العدل يمكن الفوز به – إنما بكلفة باهظة جداً.
وهذه بداية الحكمة لكل الثوريين، عنفيين
ولاعنفيين. إن مفهوم "التغير الاجتماعي
العميق" برمَّته يرتكز على واقع أنْ وحدهم
المقموعون سوف يقومون بشيء ما لتغيير المجتمع
– إذ إنهم وحدهم مهتمون. الرجال لن يهتموا
لتحرير النساء؛ ولا الأسوياء لتحرير
اللوطيين والسحاقيات؛ ولا البيض لتحرير
السود؛ ولا الرأسماليون لتنظيم نقابات؛ ولا
العسكرانيون لقيادة حركة نزع السلاح. هذا لا يعني أنه لن يوجد بعض
الرجال، أو بعض البيض، إلخ، ممَّن سوف
ينخرطون في النضال من أجل التحرير. ولكن،
جماعياً، لم يحرر البريطانيون الهند – بل
الهنود فعلوا. بيض الجنوب لم يضعوا حداً لجيم
كراو – بل السود فعلوا. فحيثما يوجد ظلم لا
ينزل الله ملوِّحاً بيديه ويوجِد العدل. نحن
من نفعل ذلك وإلا فلن يُفعَل. هذا ليس من الإنصاف في شيء،
تقول! طيب، إنه ليس كذلك. لماذا تعيَّن على سود
الجنوب، الذين عانوا بهذا العمق وبهذا الطول
من العنصرية، أن يتحملوا العبء الرئيسي
للتغير الاجتماعي؟ السبب الوحيد هو أن ما من
سواهم مهتم فعلاً. إيجاد
العدل
لو أنك تتبعت بداية هذا
الاستكشاف لفلسفة اللاعنف لتذكَّرتَ أن
المجتمع منخرط دائماً في سيرورة التغير، وأن
ذلك التغير يتضمن الشقاء دائماً. إن إيجاد
النظام الرأسمالي – الذي نأمل باستبدال شيء
آخر به ذات يوم – قد جلب شقاء هائلاً للغالبية
الساحقة من الناس. (مع أن الإنصاف يقتضي منا
الإقرار بأن الحياة قبل الرأسمالية لم تكن
نزهة – وقلة مستعدون لمقايضة "حيث صرنا
اليوم" بـ"حيث كنَّا حينذاك".) لقد أوجد ترسيخ العبودية،
في هذه البلاد، جملة من المظالم المعنِّدة
التي، من بعض الأنحاء، ما زلنا من معافستها في
طور البداية. فإذا كنا نريد أن نغير هذا الوضع
– العسكرانية، العنصرية، الاستغلال
الاقتصادي لحاضرنا – يجب علينا أن نقبل أن
مثل هذا التغيير لابدَّ أن يجلب الألم أيضاً.
إذا نظَّم العمال أنفسهم في نقابات قوية،
فهذا من شأنه أن يقلل من مكاسب أرباب العمل.
فللتخفيف من ذلك الألم سوف يستخدم هؤلاء سلطة
الدولة ووسائل الإعلام (والكنيسة مراراً)
كاملة من أجل الطعن في الحركة النقابية. بما أننا ترعرعنا في مجتمع
يرى أن النقابات تتمتع بالشرعية فمن السهل أن
نتناسى أنه، حتى وقت قريب جداً، حصلت معارك
عنيفة، ليس في حقول الفحم وحسب، بل وفي
المصانع في الشمال، بين العمال وأرباب العمل.
وأقرب إلينا زمنياً – ولكن أنأى باطِّراد –
هناك قصة حركة الحقوق المدنية. وأقرب أيضاً
كانت حركة فييتنام. والسجل بيِّن في كل حالة
منها: كان على الساعين إلى العدل أن يدفعوا
الثمن الأبهظ. ليس هذا من الإنصاف في شيء،
لكنها الحياة. مات مارتن لوثر كنغ الابن –
واحد من سلسلة طويلة من المقاومين، بمن فيهم
قادة الجمعية القومية من أجل ترقِّي
الملوَّنين، والطلاب، وقادة الكنائس، ممَّن
صُرِعوا بالنار، شُنِقوا عسفاً، أو تلاشوا في
الليل. قلة قليلة من ولاة العدل الجنوبيين
قُتِلوا (لا أتذكر أي واحد). فلو كانت الحياة
منصفة لكان الموتى أحياء، ولكان قتَلَتُهم
أمواتاً. إن على مَن اختار منَّا،
لسبب من الأسباب، تغيير المجتمع أن يقبل أن (أ)
التغيير يعني الألم و (ب) أننا سنحظى بأكثر من
نصيبنا المنصف منه. نحن مخيَّرون بين "الثأر
أو التغيير" – ولا يصح أن نجمع بين الاثنين.
وهذا صحيح سواء كنَّا سلميين أو كنا ممَّن
يؤمنون بالعنف. انظروا إلى فييتنام، حيث قضية
الفييتناميين، في ميزان العدالة، أعدل بما لا
يقاس من قضية الأمريكيين. ومع ذلك فقدنا حوالى
55000 قتيل، بينما فَقَدَ الفييتناميون أكثر من
مليون قتيل. وأولئك الذين جرُّونا إلى هذه
الحرب إما ماتوا ميتة ربِّهم أو، مثل روبرت
مكنمارا، زاروا فييتنام. الثوري يعلم أن الغاية إنما
هي التغيير العميق، وليست تصفية حسابات قديمة.
من هنا يرحِّب الفييتناميون بأمريكيين
قاتلوهم. غايتنا، مثلهم، هي مجتمع جديد؛ وهذا
ينبغي أن يشمل من كانوا بالأمس أعداءنا. إن
الغاية من ثورة ناجحة هي المصالحة بعد
التغيير الاجتماعي. (والأفارقة الجنوبيون
يلقنوننا درساً مذهلاً في هذا، في كيفية
التعامل مع مَن ارتكبوا جرائم في ظل النظام
القديم – إذ صدر عفو بحقِّهم.) هذا كلُّه ليس من قبيل
التجريد بنظر السِّلمي. وهو يعني أننا، بما
أننا نعلم أن خصمنا هو أيضاً فرد من أفراد
أسرتنا – وقد يحدث مراراً، في النزاع المدني،
أن يكون خصمنا فرداً من أسرتنا بالمعنى
الحرفي – أكثر استعداداً لتلقي الألم من
إنزاله بغيرنا. لست أحاول أن أجعل من الألم
صنماً؛ إذ إني لست مازوخياً. الحياة طيبة،
ونحن نريد أن نحدَّ من الألم بقدر المستطاع،
ونتمتَّع بخير ما في الحياة. (رباه! لهذا نعمل
من أجل التغيير الاجتماعي أصلاً!!) ما أطرحه هو
أن الجهد لتجنب ذلك الألم – الإصرار على حمل
سلاح بحيث إنه "إذا اختلط الحابل بالنابل،
أفضل أن أرديه على أن يرديني" – ليس الجواب.
ففي فييتنام، حيث استُخدِم السلاح، عيث في
المجتمع فساداً. وفي بلادنا، حيث كان
الانقسام بين السود والبيض على ما هو من عمق،
إنما اختير اللاعنف، لم يُعَثْ في المجتمع
فساداً. لقد نلنا من أيام العبودية والعنصرية
ما يكفينا من جروح – فلم نكن بحاجة إلى مزجها
بحرب أهلية جديدة. (حربنا الأهلية مثال ممتاز
على الأثر المروِّع للعنف كعامل للتغيير – إذ
لقد أخَّر الشروع في التعامل مع واقع
العنصرية حتى أواسط القرن العشرين، وجلب على
كلا بيض الجنوب وسودهم أهوالاً من الألم –
ألماً وتجويعاً لم يدوَّنا في كتب التاريخ.) عوامل
الظلم – النيل منها
من القضايا التي لا تني تطفو
كيفية التعامل مع قضية وحشية الشرطة. يمكننا
أن نرتكب هنا الغلط نفسه الذي ارتكبتْه حفنة
من "يساريي" الطبقة المتوسطة عند بداية
حرب فييتنام عندما سدَّدت على قواتنا نفسها
باعتبارها العدو، أو يمكننا أن نتعلم من
التاريخ. إذا كنت تريد أن تتغير عليك أن تتكيف
مع الأشياء كما هي. لينين، القائد البلشفي
للثورة الروسية، الذي لم يكن سلمياً قطعاً،
لم يشجِّع قومه على شتم القوات القيصرية –
لا، بل شجَّع على حوار سياسي معهم، عالماً أن
القوات المسلحة للنظام الروسي القديم كانوا
مجرد "عملاء" تستخدمهم الطبقة الحاكمة.
فلو كنت تريد أن تستيقن من استمساك القيصر
بالسلطة، لألقيت الحجارة على قواته، مما
يجعلهم يكرهونك. أما إذا كنت تريد أن تُسقِط
القيصر، لفعلت عندئذٍ ما فعله قوم لينين –
لانتهزت كل فرصة متاحة لفتح حوار سياسي مع
الشرطة والقوات بحيث، في المآل، لحظة
التأزُّم، يرفض الشرطة الانصياع لأوامر
القيصر. فلننتقل قدماً في الزمن إلى
مظاهرات واشنطن دي سي الكبرى ضد حرب فييتنام،
وإلى اليوم الذي جاء فيه قدماء محاربي
فييتنام يلقون بأوسمة شرفهم من على سور البيض
الأبيض إظهاراً لاحتقارهم للحرب. ولقد حرصوا،
قبل ذلك الفعل بعدة أيام، على توزيع "رسالة
إلى إخوتنا في البزَّة الزرقاء" على مراكز
الشرطة في واشنطن دي سي، شارحين فيها ما هي
الحرب، ولماذا سوف يجازفون باعتقالهم. لقد
قلل هذا التصرف من قدرة الشرطة على التعامل
بقسوة مع المتظاهرين. أعلم من خبرتي أن غالبية
الذين سمُّوا الشرطة "خنازير" إبان فترة
فييتنام كانوا إما من عملاء الشرطة
المكلَّفين باستفزاز الصِّدامات، أو كانوا
من المستجدين في الحركة. لم أتقدم بهذه الحجج لأنها
"لاعنفية" بل لأنها ناجعة، لأنها عملية. وهذا،
بالطبع، ما يجب أن يكون عليه اللاعنف – طريقة
عملية، قابلة للتطبيق، لتغيير المجتمع، وليس
جملة مجرَّدة من النظريات. يكمن ظلم حركات التغيير
الاجتماعي كافة في أنها تتطلب من الملتزمين
منَّا بالتغيير بتكبُّد ألم التغيير بدلاً من
محاولة فرضه على المقموعين. ثمة هنا عبرة
نفسانية عميقة. إذا كان قامعوك يرون فيك امرأً
يرمي الحجارة والشعارات ويعاملهم كموضوعات
للحقد، فهذا يعزز فيهم اعتقادهم بأنك تستحق
كل مثقال ألم ينزلونه بك: كل ضربة، كل مدة حبس،
وعند الضرورة كل رصاصة. لكننا عندما نثبت على
موقعنا، ونعاني بدون أن نردَّ، ونقبل الضربات
بدون أن نسدِّدها، ينفتح الطريق للخصم ليرانا
كبشر وليشكك في سلوكه. وحِّد
أنصارك، فرِّق أعداءك
إن "الحذاقة" في
اللاعنف هي في إيجاد طريقة لتفريق معارضيك،
بينما تحافظ على جانبك متماسكاً. فلو أن مارتن
لوثر كنغ الابن استخدم العنف لكان هذا الأمر
فرَّق الطائفة السوداء بطرق عديدة – بين
أولئك الخائفين من استخدامه، وأولئك الأضعف
من استخدامه، إلخ. – ولكان وحَّد الطائفة
البيضاء ضدَّه. لكن اللاعنف كان شيئاً يستطيع
القيام به كل أسود جنوبي، مهما كان ضعيفاً،
مسناً، أو مريضاً. لقد تطلب الشجاعة، لكنه
لم يتطلب تدريباً عسكرياً. ولقد فرَّق
الطائفة البيضاء، لا بل فرَّق الأمة. لو كانت الحركة السوداء
الجنوبية اعتمدت العنف (الذي كان يحق لها
أخلاقياً أن تعتمده) لأصاب الذعر الأمة
بأسرها. أما وأنهم كانوا لاعنفيين فقد أوجدوا
ضغطاً قومياً ذا وزن على البيت الأبيض لكي
يتدخل. و"الحذاقة"، بالطبع، ليست حذاقة
على الإطلاق. فحيث كان معارضوك يتوقعون الغضب
والكراهية تقدِّم أنت المحبة (أو أقرب ما
تستطيع تحقيقه منها). وحيث تصر المعارضة على
رؤيتك كشيء تصرُّ أنت على معاملة المعارضة
بوصفها مؤلَّفة من أفراد فريدين يستحقون
الرحمة. وباختصار، يمكننا أن نغير شروط
الصراع، يمكننا أن نحوِّله – وفي سياق ذلك،
بينما نضطر إلى "التألُّم ظلماً"، يولد
الأملُ بالعدالة من هذا المخاض. ليس في
التاريخ من عدل، اللهم إلا من إيجادنا نحن.
وإيجاد العدالة يقتضينا أن نقبل جزءاً كبيراً
من وجع الصراع والتغيير. لماذا نفعل هذا؟
لأننا، بنعمة من الله أو مصادفة، وقعنا على
حقيقة علَّمتنا أن معارِضنا هو أخونا، أختنا،
ولسوف ندفع ثمناً باهظاً جداً، إذا لزم
الأمر، قبل أن نُنزِل بالآخرين الوجع الذي
أنزله التاريخ بنا. غايتنا هي التحوُّل
والمصالحة، وتلكم هي ماهية الثورة. أجل،
ولكن ماذا عن هتلر؟
عند نقطة ما يواجه
السِّلميون هذا السؤال التقليدي، المصاغ
بطرق عديدة مختلفة "أجل، ولكن ماذا عن
هتلر؟" يمكن أيضاً أن يكون "أجل، ولكن
ماذا عن شارون... ابن لادن... المجرمين...
الفاشيين... العنصريين... الصرب... الكروات...
الإسلاميين...؟" للوهلة الأولى، لا يوجد
أغرب من مفهوم شعب أعزل يتحدى قوة محتلة (الهند)
أو بنية عنصرية قمعية ظالمة (الولايات
المتحدة). لكن بعضهم يستبعد هذه الانتصارات
بحجة أن هذه التكتيكات لا تصلح ضد هتلر – أن
"اللاعنف يتطلب بالفعل خصماً إنسانياً،
مسيحياً، شريفاً، ديمقراطياً... من نحو
الجنوبي الأبيض أو البريطانيين... وإلا فسوف
يخفق". إن جزءاً من المشكلة هنا هو
الأسطورة. لم يؤتَ البريطانيون من "اللطف"
إلا قليلاً. سأعود إلى ذلك بعد قليل. ولكن
أولاً، هناك "حقيقة رهيبة" علينا جميعاً
أن نواجهها، سواء كنَّا سلميين أو أكثر
الإرهابيين العنيفين عزماً – لا يمكن
الانتصار في كل المعارك. هناك أوقات لا يصلح
فيها شيء. (وهذا لا يعني أننا يجب ألا نحاول
– فنحن لا نعلم متى يوشك مدُّ التاريخ على
الانحسار.) لم تكن العنصرية أقل شراً في
مونتغومري، ألاباما، عام 1955 عندما بدأت حركة
مقاطعة باصات مونتغومري، منها عام 1915. ولا
كانت هذه أول مقاومة؛ إذ لقد كان السود قد
جازفوا بحياتهم، بل وفقدوا حياتهم إبان "تجربتهم
الأمريكية" قاطبة. أحياناً
لا ينجح شيء
في جنوب أفريقيا، قبل عقود
مضت، نهضت حملة لاعنفية قادها موتيلال، ابن
غاندي – لكنها أخفقت. وحتى الآن – لنكن
صريحين دون تجمُّل – أخفقنا في هذه البلاد في
مهمة "قلب أمريكا". فعملنا، من بعض
الوجوه، أصعب من عمل غاندي – إذ كان الهنود
يعلمون أنهم ضِعاف عسكرياً بالقياس إلى
البريطانيين فكانوا على استعداد للفحص عن
بدائل، بينما الأمريكيون يعتقدون أنهم
أقوياء بسبب الأسلحة التي بحوزتهم – وهم
بالتالي متقاعسون عن النظر في بدائل. ولكن لنعد إلى البريطانيين
وإلى أولئك "المسيحيين الجنوبيين اللطفاء".
كان البريطانيون حكاماً إمبرياليين، قمعيين،
عنيفين عند اللزوم، ولئن كانت ثمة مفارقات في
حكمهم للهند تعود هذه المفارقات إلى شيء من
اللياقة الملازمة للإمبريالية البريطانية
أكثر منها إلى الاهتمام الذاتي. فضلاً عن أن
مناخ الهند المداري لم يستقطب أعداداً كبيرة
من الإنكليز. فلكي يحكموا الهند الشاسعة
اعتمد المستعمرون على "أهليين" مدرَّبين
لإدارة المحاكم والشرطة والنقل والخدمات
البريدية إلخ. فمن وجهة نظر ماركسية كانت ثمة
تناقضات تتراكم. لقد درَّب البريطانيون
الهنودَ على مهارات إدارة الهند، لكن النتيجة
كانت، بالدقة، خلق تلك النخبة المتعلمة التي
قادت حركة الاستقلال. لقد درس غاندي الحقوق في
لندن، وذهب إلى جنوب أفريقيا كواحد من
المحامين والموظفين الحكوميين الكُثُر الذين
درَّبهم البريطانيون لإدارة إمبراطوريَّتهم.
لم يكن ثمة شيء يتميَّز به البريطانيون على
الألمان من حيث اللطف. لقد كانت ألمانيا أكثر
أمم أوروبا تحضُّراً في الثلاثينات. أجل، لقد
كان هتلر وحشاً، لكنه لم يكن أجنبياً. ثانياً،
لأنه قد تم توثيق الهولوكوست، ولأنه وقع في
وسط أوروبا (ولأن "جانبنا" انتصر) فإننا
نعرف الكثير عنه – وقد نظن أنه فريد من نوعه.
بيد أنه، بكل أسف، لم يكن كذلك. فسجلات تجارة
العبيد تجيز الاعتقاد بأن أعداداً اكبر من
الأفارقة ماتوا إبان تلك التجارة، والحقائق
عن الحكم البلجيكي للكونغو تصدم – إذ في فترة
قصيرة أعقبت سيطرة البلجيك على البلاد في
القرن التاسع عشر قتلوا من الأفارقة أكثر مما
قتل الألمان من اليهود. الشر في الأمور
البشرية عالمي، لم يحتكره النازيون. الشر
في الأمور البشرية
الأمريكيون بحاجة إلى إمعان
النظر في تاريخنا. لست أحاول الانتقاص من
الهولوكوست. بل إني أرجو من الأعضاء
المحليين لرابطة مقاومة الحرب أن يتذكروا يوم
22 نيسان، يوم ها شُواه، وينظموا احتفاء
تذكارياً به في جماعتكم. ولكن ما من سلمي يحق
له أن يتورط في محاججة من نوع "ألمي أعظم من
ألمك". لكننا ملزَمون بالصدق فيما يخص ما
شاركنا فيه، نحن أو أمتنا. إن وجع أربعة قرون
من العبودية يقف على مستوى الهولوكوست نفسه.
ولدى قراءة مقال في مجلة النيويورك تايمز
عن حرب فييتنام (8/10/97)، كان الرقم المقبول
لموتى الفييتناميين هو 3,6 ملايين. كانت
جريمتهم الوحيدة هي الدفاع عن أمَّتهم ضد
غازٍ خارجي – نحن. (فكما أوردت التايمز،
هذا العدد من الموتى مكافئ، على أساس العدد
النسبي للسكان، لـ 27 مليون أمريكي.) عندما
يقول أحدهم: "السِّلمية جيدة لكنها ما كانت
لتنفع ضد هتلر"، عليه أن يعتبر أن لِندون
جونسون كان هتلر بنظر الفييتناميين، وأن جيم
كراو كان هتلر بنظر أمريكا السوداء. لن نعرف
أبداً فيما إذا كان اللاعنف سوف ينفع ضد هتلر (أو
فيما إذا كان سوف ينفع ضد الأمريكيين في
فييتنام لو أن الفييتناميين اختاروا ذلك
المنهج). إن تاريخ الهولوكوست يُظهِر مقاومة
قليلة، إن لم نقل معدومة، من جانب اليهود
لهتلر؛ ولا عجب في هذا – إذ ما كانوا ليصدقوا
أن شيئاً رهيباً كـ"الحل النهائي" سوف
يُخطَّط له. (تاريخياً نجا اليهود من العداء
للسامية بالحرص على البقاء بعيداً عن الأنظار.)
وقد قال بعضهم: "كان اليهود سلميين وانظر ما
قد حلَّ بهم!" آسف، لقد كانوا سلبيين –
وهناك فرق شاسع. ما من طريقة تسمح بمعرفة ما
إذا كانت السِّلمية الفاعلة سوف تتمتع بحظ من
النجاعة – فكل ما نعلم هو أنها لم تجرَّب.
أتذكر هنا استنتاج حنة أرندت القارس في
كتابها عن آيخمن، الذي خلصتْ فيه إلى أن
التعاون السلبي ليهود أوروبا مع النازيين هو
الذي جعل الهولوكوست ممكناً. إذا فكَّرتم في
هذا لوهلة، ستجدونه، بكل أسف، صحيحاً. فإن
تتبُّع أثر، وتوقيف، ونقل، وقتل ستة ملايين
شخص يقاومون – حتى بعدم التلبية عندما
يؤمَرون بذلك، لابدَّ، على الأقل، أن يتسبب
في فوضى عامة ضخمة. (بالطبع ليس أسهل من القول:
"... لكنتُ قاومتُ" – عاطفة رخيصة يعرب
عنها أناس لم يكونوا هناك. بعض الوثائق يُظهِر
شيئاً من المقاومة، من نحو انتفاضة غيتو
وارسو. عنفيين أو لاعنفيين، يبجِّل
الراديكاليون المقاومة.) بعض
الانتصارات المعزولة ضد هتلر
ولكن ضمن أوروبا المحتلة
حصلت انتصارات جيدة التوثيق للاعنف. ففي
النرويج حصل إضراب ناجح للمعلمين ضد إرغامهم
على تدريس الإيديولوجيا النازية. وفي
الدانمرك كانت معارضة النازيين بقيادة الملك
الذي قال إنه إذا أرغِم اليهود على وضع "نجمة
داود الصفراء"، لكان هو، الملك، أول رجل في
الدانمرك يضعها. وعندما تحرك النازيون
الاعتقال اليهود الدانمركيين، سرَّب عناصر
من الغشتابو هذا الخبر إلى السلطات
الدانمركية وفي غضون 48 ساعة تم ترحيل جميع
اليهود تقريباً في الدانمرك إلى الأمان في
السويد. وفي بلغاريا، التي لم يعرف تاريخها
عداء للسامية، حالت المقاومة المدنية
العفوية (بما فيها حشود الناس الجالسين على
سكك الحديد) دون النازيين وشحن أي من اليهود
خارج البلاد. "أولئك
المسيحيون الجنوبيون اللطفاء"
من كل الأماكن التي ظن
الأمريكيون أن مقاومة جيم كراو سوف تبدأ
منها، كان مونتغومري، ألاباما، قلب التحالف،
آخرها. أتذكر رحلة بالباص عبر الجنوب العميق
عام 1951، عائداً من رحلتي الأولى إلى أوروبا (من
مؤتمر للشباب السِّلمي في الدانمرك).
مستلهِماً بايارد رَستِن ورحلة المصالحة
ركبتُ طريق باص غرايهاوند الجنوبي عائداً من
نيويورك إلى لوس أنجلس. كانت تحدياتي لجيم
كراو حَيِيَّة – كنت وحدي ولم أكن جَسوراً
جداً حتى في حشد. لكني حظيت بنصيب رؤية طبيعة
السَّفَر عبر الجنوب العميق والإحساس بها في
أوائل الخمسينات. لقد مضى الآن على ذلك من
الوقت – نصف قرن تقريباً – ما يجعل ألاباما
بعيدة عنَّا بُعد ألمانيا النازية. لكن
المعارضة الجماهيرية المذهلة للعنصرية بدأت
من هناك، في الجنوب العميق، حيث لم يكن مصدر
الخطر الأكبر الذي يتعرَّض له الناشط من أجل
الحقوق المدنية هو [الكوكلوكسـ]ـكلان بل والي
العدل، حيث لم يكن ثمة التماس للقانون، حيث لم
يكن يحق للسود أن يصوِّتوا، حيث كان الليل
وقتاً للرعب وليس للراحة. لا تذكُرْ أمام كبار
السن من الجنوبيين السود مقدار الأمان في
اللاعنف حينئذٍ! فاللاعنف لا يستطيع أن يفوز
في كل صراع – إذ إن هناك هزائم. بيد أن هذا ليس
سبباً أوجَه لترك اللاعنف من تخلِّي العسكري
عن أسلحته إذا خسر معركة. (ملحوظة فلسفية: في
كل صراع عسكري هناك منتصر ومهزوم، وبالتالي
فإن العنف يخفق نصف الوقت ويفوز نصف الوقت
الآخر. لكن الهدف في الصراع اللاعنفي ليس
إيجاد منتصر بل تغيير الوضع نفسه – وهو
مفهوم مختلف جذرياً.) ***
|
|
|
|